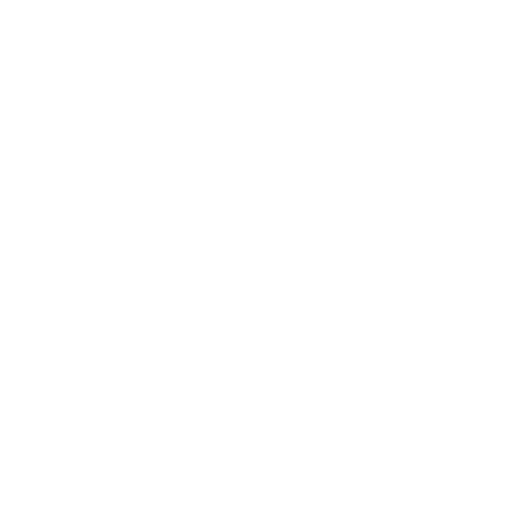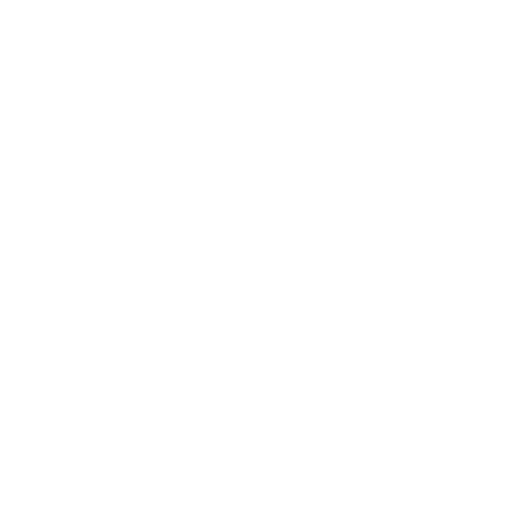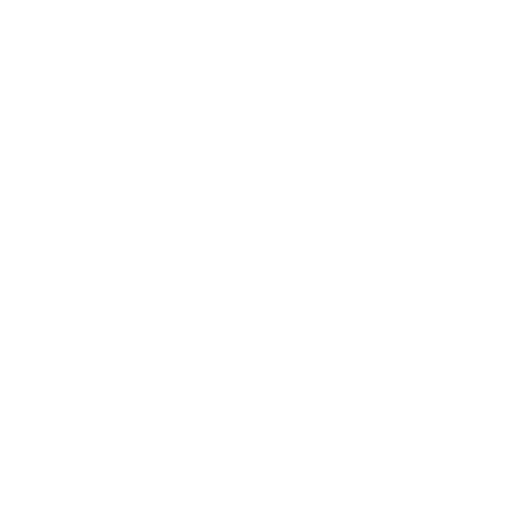لدينا من يصنع الوهم، ويعيشه، ثمَّ يصدِّره، ويطلب ممَّن حوله أن يجاريه في ذلك.. فهو كما قيل يكذب ويكذب حتى يصدق كذبته.
لدينا بعض المُسلَّمات التى عَفَى عليها الزمن، وأظن -وكل ظني أثمٌ- دائما بأنه حان الوقت للمراجعة والجدية فيها لعل وعسى.
علينا أن نتساءل: ماذا عن حدائقنا الخلفية؟ هل جربنا يوما إلقاء بعض أفكارنا ومخلفات قصاصاتنا فيها لعله تهبُّ عليها ريح عاتية تُريحنا من أعبائها، وإعادة تدويرها جيلًا بعد جيل.
ما الفارق بين من يحمل الدكتوراه وذاك العامل المخلص المثقف الذي يقوم بعمله بكل أمانة وبروح رائعة، فيها الكثير من الإحساس بأن ما يقوم به خدمة مهمة لمجتمعه ونفسه وأسرته، بعكس من أمضَى سنوات من عمره يتعلم وهو يعتقدُ ذلك؛ علما بأنه لا يعلم الحدود الجغرافية لبلده، ولا حتى الميناء الرئيسي لها؟
أيُّهما أجدر بالاحترام: من يخدمك ويُسعده ذلك، أم من يخدمك وهو يعتقدُ أنَّ ما يقوم به تفضُّل وتكرُّم منه.
يُقال إنَّ الناس مقامات، ونحن فهمنا ذلك! ولكن حسب تصنيفنا، ومستوى أفكارنا، وليس كَمْ معنا وكَمْ معكم!!
الجامعات لا يُدرس بها معنى أن تكون أخلاقيًّا وإلا لكنت أنا أول الفاشلين.
مُنتهى الأشياء الكمال، وكُلنا ننشده، ونسعى له، ولن يكون ذلك ونحن نسكُن تلك البروج التى بنيناها وقد ضاقتْ بها أحلامنا وأخلاقنا.. نسمع ونردِّد لو الأمر بيدي، وعندما يصبح كذلك ترى عجبا، وقد لا ترى صاحبه أبدا.
أحلامُنا تتجاوز ما نملكه من ثقافة حقة تجعل من كل شخص يعرف دوره وموقعه، وماذا سيقدِّم لمجتمعه. سبقنا إلى ذلك مجتمعات مرَّت بنفس التجربة، وها هى الآن طريق لمن أرد المسير. الأمم تُفاخر بما أنجزت، وليس بما كانت عليه، فالأمس ولَّى وذهب، واليوم أقبل وحل. فهل لنا فيه نصيب؟
أعتقدُ أنَّ المهنة بمعناها الحقيقي هي مفتاح العمل وطريق البناء، وليست تلك الأوراق التى نُفاخر بها، ثم ننام ننتظر فرجًا لن يأتي.. اسألوا “إخصائي النظافة في الشرق”، فلرُبما وجدنا لديه إجابة.
——————–
ومضة:
“غُربال الحقيقة مهما فعلتْ سيُعِيدها كما هي”.