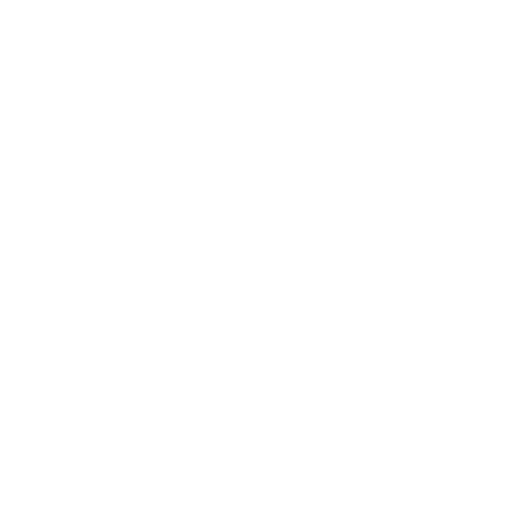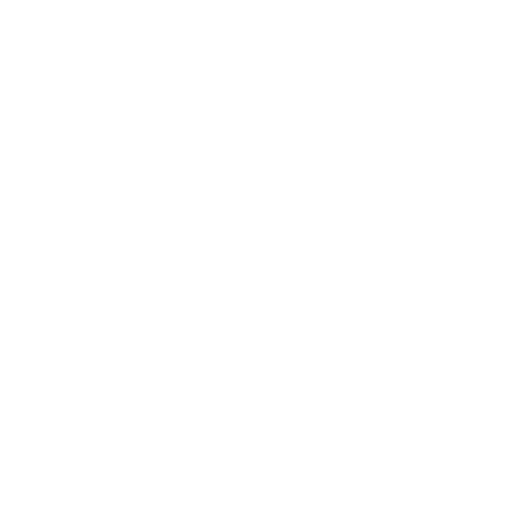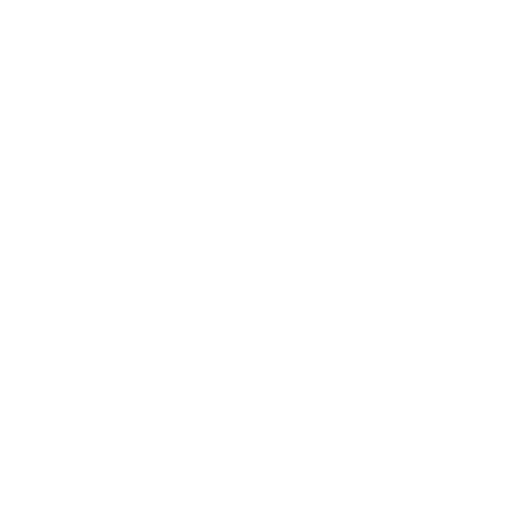الانفتاح كلمةٌ جذابةٌ وبراقة، دعونا نتفق على أنه مطلوب؛ لنتجاوز بذلك الصراع حول الإجابة على سؤال: هل نحن معه أو ضده؟ لنصل إلى الجدال والحوار الأكثر فائدة؛ وهو الإجابة على سؤال: ماهو الانفتاح المطلوب أو الواعي؟
لأن الانفتاح شأنه شأن أي معنى سامٍ ربما مُورس باسمه ما ليس منه.
والسؤال هذا كبير، وسال حبرٌ كثير في الجواب عليه، وما أحب تسجيله هنا – مساهمة مني في الجواب على هذا السؤال- هو في استلهام بعض المعاني حول هذا الموضوع من موقف النبي عليه السلام في يوم عاشوراء.
فقد تجلى في هذا الموقف، شروط الانفتاح الواعي، المتمثل في:
– قبول الحق وكل ماهو نافع من الآخر، وهو الذي يمثله ويدل عليه قول النبي عليه السلام: نحن أحق بموسى منكم، فصام هذا اليوم وأمر بصيامه.
وهذا الشرط هو الذي يحول بيننا وبين الجمود والانغلاق، واعتقاد أننا نحوز كل الخير والصواب، ولسنا في حاجة لغيرنا.
– احترام الذات والهوية والخصوصية، الذي يمثله ويدل عليه، قول النبي عليه السلام: لإن حييت إلى قابل لأصومن التاسع، وهو الشرط الذي يحول بيننا وبين الذوبان.
غياب هذين الشرطين في انفتاحنا على الآخر يُحدثُ إحدى الآفتين، إما الجمود وإما الذوبان، وهي الآفتان التي نتأرجح بينهما.
فآفة يمثلها فريق، يعتقد أن كل شيء يصدر من الآخر، فهو مرفوض، أو محل شك وتردد، وربما أبدعوا في استنباط وجوه الشر لأي جديد يطرأ.
وفريق آخر يعتقد أن كل ما يصدر من الآخر، فهو محل ترحيب، ودليلٌ على التطور والتحضر، حتى لو كان مصادماً ومناقضاً لثوابتنا الدينية والأخلاقية والاجتماعية.
وكلا الفريقين وجهان لعملة واحدة، يجمعهما، أنهما قررا سلفا تعطيل عقولهما، واصدار أحكام أولية بالقبول أو الرفض، دون أن يبذلا جهداً في الفحص والنقد والتمحيص، فيرفض أحدهم دون أن يعلم لماذا رفض، ويقبل أحدهم دون أن يعلم لماذا قَبِل؟!
ومن أشد آفات العقول أن تفقد خاصية النقد والتمحيص، وتصبح مرتعاً خصباً لكل دعاية وفكرة وسلوك مهما كان هابطاً وسخيفاً، تماماً مثل الحمى المستباح بلا سياج يحميه.
فاليوم على قناعات ومواقف، وغداً على نقيضها تماما، دون أن يشعر أحدهم بأي خجل أو تناقض؛ لأن ادراك التناقض يحتاج إلى معايير يحتكم إليها العقل، وهذه العقول معيارها الوحيد هو ما يروج ويفعله الناس، فالصواب ما يفعلونه، والخطأ ما يتركونه ويرفضونه.
فيصبح حالهم كما يصف عمران بن حطان:
يوماً يمانٍ إذا لاقيتُ ذا يمنٍ
وإن لاقيتُ مَعْدِياً فعدناني
والله في القرآن الكريم شنع على أرباب هذه العقول، التي تتابع دون وعي وإدراك، وبيّن أن مصيرهم النار؛ لأنهم عطلوا عمل هذه العقول التي وهبهم الله إياها، كما في قوله تعالى: ﴿إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب﴾
والنبي عليه السلام حذرنا من الأمعيّة؛ بأن نتابع الناس في الخير وفي الشر دون وعي وإدراك، فقال:
“لا تَكونوا إمَّعةً، تقولونَ: إن أحسنَ النَّاسُ أحسنَّا، وإن ظلموا ظلَمنا، ولَكن وطِّنوا أنفسَكم، إن أحسنَ النَّاسُ أن تُحسِنوا، وإن أساءوا فلا تظلِموا “.
ليرشدنا بذلك أن نتجافى عن الفريقين السابقين، لنكون فريقاً ثالثاً، وهو المأمل عليه والأليق بالمسلم، الذي لديه حركة عقل مستمرة ومستنيرة، في كل مرة يَفِدُ فيها الجديد، ليقيسها ويفحصها على مالديه من معايير الحق وعلى قيمه ومبادئه؛ فإن كان خيرا فشعاره “نحن أحق بكل خير”، وإن كان شراً تمايز عنه ولم يشارك الناس شرهم، كما امتاز الرسول عن اليهود بصيام اليوم التاسع، فيجمع بذلك بين اقتباس كل ما يفيد وبين الحفاظ على هويته وتمايزه عن غيره.
فنحوز بهذه العملية الواعية لمجتمعنا فضائل الناس وننفي عنه خطأهم ونقصهم، لنصل بذلك إلى مرحلة النضج والتطور الحقيقي، التي هي دائماً نتيجةُ الانفتاحِ والاختيارِ الواعي.
المشاهدات : 35259
التعليقات: 0