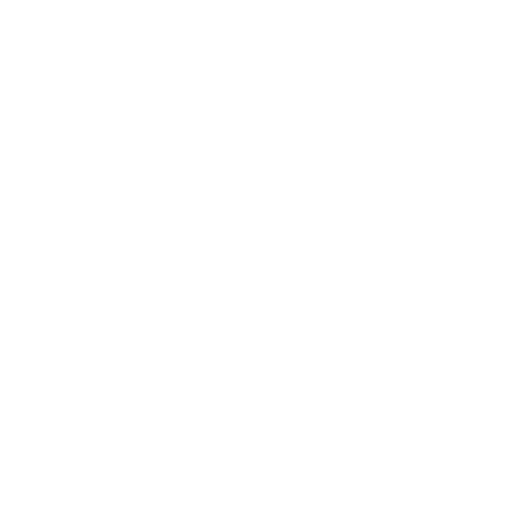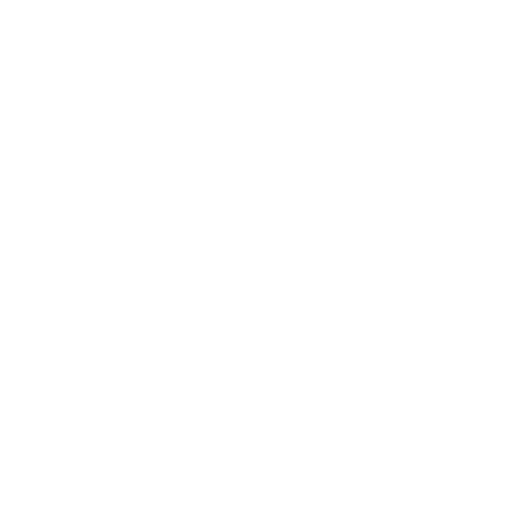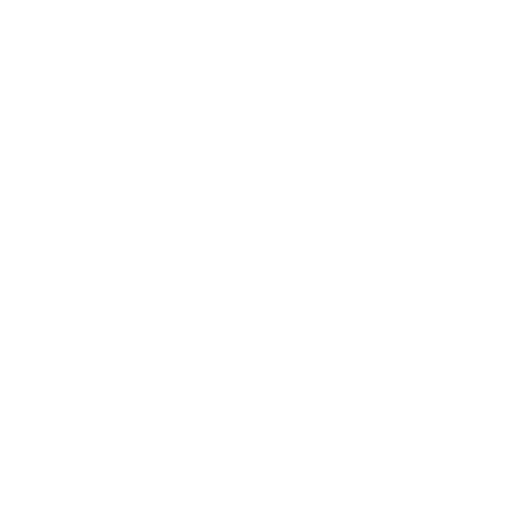أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، المسلمين بتقوى الله عز وجل.
وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم: من طبيعة ابن آدم، ومن دلائل ضعفه؛ ما يعتريه من أحوال التقلب والتغير والتبديل؛ فيقع في التردد والاضطراب والتناقض واشتباه الأمور وعدم الاستقرار؛ فقد يتبنى قولاً في حين ويعود عنه في المستقبل، وقد يرى رأياً اليوم وينكره غداً، ولا غرابة في ذلك؛ فالتكوين النفسي والعقلي والجسدي للإنسان بيّنه العليم القدير بقوله: {وخُلق الإنسان ضعيفاً} فهو ضعيف من جميع الوجوه، ضعيف البنية، وضعيف الإرادة، وضعيف العزيمة، وضعيف العقل، وضعيف العلم، وضعيف الصبر.
وأكد أنه مع هذا كله؛ فمما يميز المؤمن ويدل على رجاحة عقله وإذعانه لربه رجوعُه إلى الصواب، وتركه ما يتبين له فيه خطؤه وما يعاب؛ فهو لا يستنكف أن يعود عن قوله أو فعله أو رأيه متى وجد الحق في غير ما ذهب إليه، ولم يستمر فيما كان عليه، وهو لا يكترث بمن يصفه بالتقلب أو تغير الرأي.
وقال: الرجوع إلى الحق فضيلة، وهو عزة النفس الحقيقية، لا كما يزين الشيطان لبعض الناس أن العزة في الثبات على الرأي وإن كان خطأً، قال الله تبارك في علاه: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} قال ابن كثير رحمه الله: “أي تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده؛ فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب”.
وأضاف: هذه فرصة لنا أن نراجع أعمالنا بين الفينة والأخرى؛ فمتى ما وقع المرء في الزلة؛ سارع بالأوبة، وبادر في طلب التوبة؛ لأنه ينشد الحق ويبتغيه، ويسعى في تحقيق أمر ربه ومراضيه، ومن فَعَل ذلك فهو داخلٌ في وصف الخيرية، الذي ذكره خير البرية، عليه الصلاة والسلام بقوله: (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون).
وأردف “غزاوي” أن منهج الإسلام يعلمنا كيف يوطن المرء نفسه على الرجوع إلى الجادة ويرتاضها على لزوم الاستقامة؛ حيث تَوَعّد النبي صلى الله عليه وسلم بالويل للذين يستمعون القول الحق فلا يتبعون أحسنه، الذين يعلمون أنه الحق ولا يعونه ولا يعملون به؛ بل يهملونه إما تكبراً وعناداً، وإما تعصباً وتقليداً، وإما غلواً وتقديساً لما هم عليه.
ولفت إلى أن النفوس الكبار لا تأنف أن تنصاع للحق، ولا ترضى أن تبقى على الخطأ، ولا تمنعها مكانتها من أن تفيء إلى أمر الله؛ فالأولى بالمسلم أن يتراجع عن عزمه في فعل شيء أو عدم فعله إذا رأى المصلحة في غير ما ذهب إليه؛ فمتى ما حلف على فعل شيء أو تركه ثم رأى أن النفع في عدم المضيّ في هذا اليمين كفّر عن يمينه وأتى الذي هو خير، وهذا ما فعله الصديق رضي الله عنه؛ فلما شارك “مسطح” أهلَ الإفك في الكلام على عائشة رضي الله عنها وخاض مع مَن خاض، قال أبو بكر رضي الله عنه: “والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة”؛ فأنزل الله: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم}، قال أبو بكر: “بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي”؛ فكفّر عن يمينه ورجع إلى النفقة على مسطح، وقال: “والله لا أنزعها عنه أبداً”.
كما استشهد بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عندما قال: (كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم، وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت؛ فسألته أن يغفر لي فأبى علَيّ، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاً، ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أثَمّ أبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجهُ النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، مرتين؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله؛ فهل أنتم تاركو لي صاحبي مرتين.. فما أوذي بعدها) فالصحابة الكرام يقع منهم الخطأ وليسوا بمعصومين؛ لكنهم سرعان ما يرجعون إلى الحق، وهذه هي الميزة العظيمة التي تميزهم.
وأكد أن هذه الأقوال والمواقف والوصايا السابقة تدل على ورع هؤلاء القوم العظماء وفضلهم وفقههم وإنصافهم؛ فحري بنا أن نتأسى بهم ونتمثل خطاهم.
وشدد على أن المراجعة المحمودة تختلف عن التراجع المذموم؛ تعني أن نصوب الأخطاء بعد معرفتها ونستدرك ما فات، حتى تبقى أعمال المرء على الصواب والخير والحق، أما التراجع المذموم فهو ترك الحق؛ فالحق المبين يثبت عليه صاحبه فلا يتزحزح عنه ولا يحيد قيد أنملة؛ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المشركون ثني عزمه عن دعوته وجهره بالحق قال لهم بكل ثبات وقوة: (أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم، قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلةً)، وهنا يتجلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تمسكه بالحق وقوة ثباته على مبدئه، وعدم تراجعه عن منهجه الرشيد، ومسلكه السديد.
وأشار “غزاوي” إلى اقتداء الأئمة والعلماء بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في الثبات على الحق، وعدم التنازل عنه بكل ما أوتوه من قوة؛ فالخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبت في حروب الردة ولم يثن عزمه عن قتال المرتدين شيء، وقال في ذلك الموقفِ العظيم كلمته الشهيرة: (والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه).
وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام، أن الرجوع إلى الحق من الخصال المحمودة والصفات الحسنة المنشودة، وأن ترك الحق والغواية بعد الهداية والرجوع إلى الباطل على الضد من ذلك؛ فترك الهدى والانسلاخ من دين الإسلام والخروج عليه بعد اعتناقه؛ أقبح صفات المرء وشر فعاله، ولا يرجع عن دينه إلا ضال مفتون وخاسر مغبون، وفعله هذا تعريض بالدين واستخفاف به، وكذلك فيه تمهيد طريق لمن يريد أن ينسلّ من هذا الدين؛ وذلك يفضي إلى انحلال جماعة المسلمين.
وقال: من عرف الدين وتغلغل الإيمان في قلبه لا يمكن أن يفرّط في التمسك به ولا يتركه ويرتد عنه؛ مهما كانت الظروف والأسباب؛ فلما سأل هرقل أبا سفيان عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطةً له؟ قال: لا، فقال هرقل: “وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب”؛ ومعنى “سخطةً له” أي: ليس من باب السخط والكره لهذا الدين؛ وإنما لمصلحة ينالها، ما ترك الدين إلا لحظ من حظوظ الدنيا، كمال أو جاه أو شهرة.
وأوضح أن من صور التراجع المذموم أن يكون العبد على رشد وبينة من أمره، ثم يتراجع عن الحق الذي هو عليه ويبدل حكم الله؛ اتباعاً لهواه ومتابعةً لآراء الناس، وهذه هي الفتنة؛ فعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، فلينظر: فإن كان رأى حلالاً كان يراه حراماً فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراماً كان يراه حلالاً فقد أصابته.
وألمح إلى أن الفرق بين هذا النكوص والتقهقر والتبديل المذموم، وبين التراجع المحمود؛ أن تغيير الرأي وتبديل حكم الله؛ باعثه الافتتان واتباع الهوى، وليس باعثه اتباع الحق والهدى، ومبنيّ على الرأي والهوى والمداهنة ولم يكن مبنياً على الدليل والحجة البينة